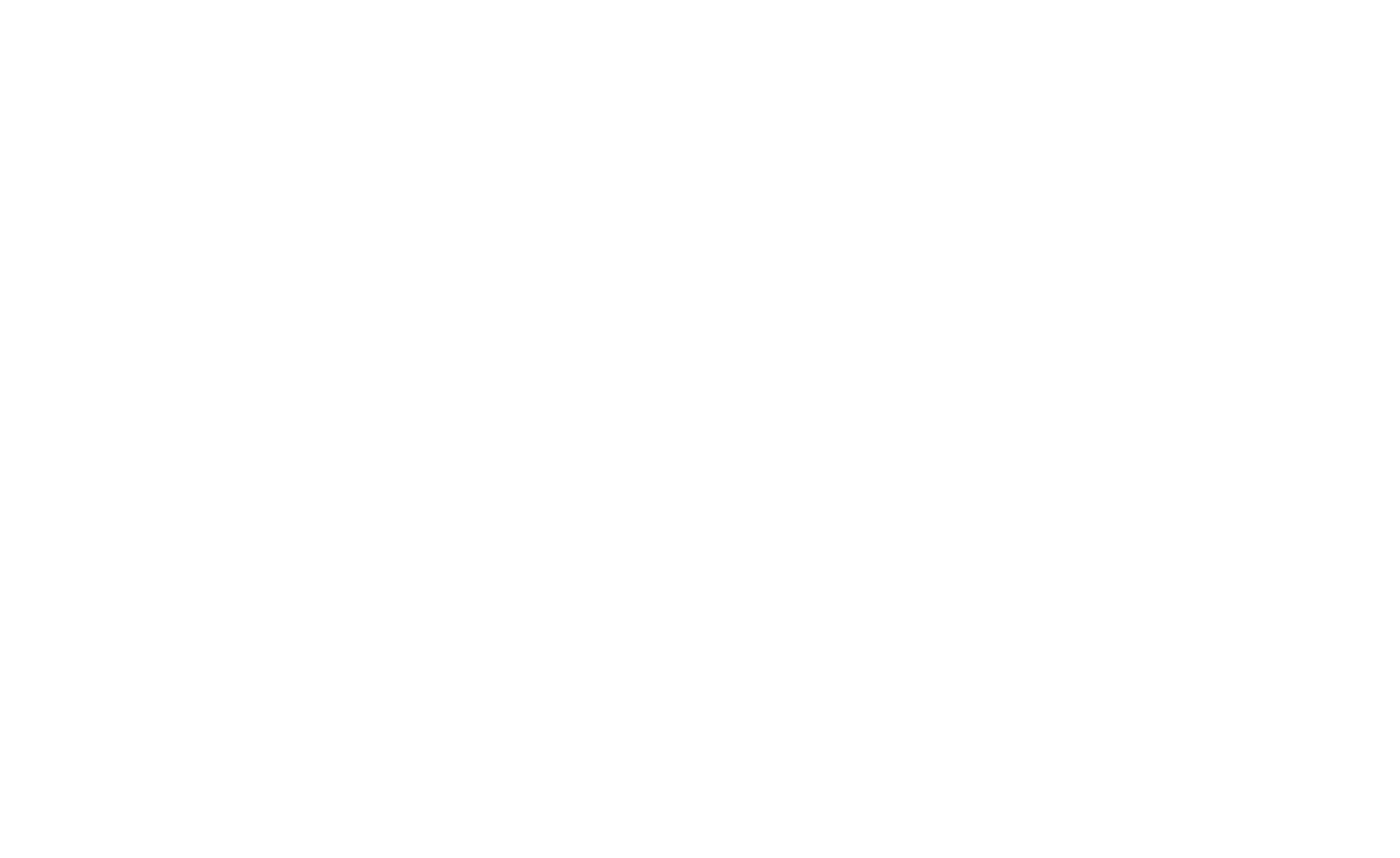منذ فجر التاريخ، كان السعي لفهم العالم دافعًا للإنسان في رحلته الطويلة نحو المعرفة. وتنوّعت عبر العصور منابع الفهم؛ من الوحي الذي أضاء للروح طريقها، إلى الفلسفة التي سعت إلى تفسير الوجود بالعقل، حتى جاءت التجربة العلمية لتُغيّر وجه المعرفة وتُعمّق نظرة الإنسان إلى الحقيقة.
في قلب الفلسفة وُلد علم الأبستمولوجيا، أي علم المعرفة، المعنيّ بدراسة طبيعتها وسبل الوصول إليها. ومنه تفرّعت مذاهب فكرية متعددة؛ كالتجريبية التي تُرجّح الحسّ، والعقلانية التي تُعلي من الفكر، والمثالية التي ترى أن العالم الحقيقي ليس سوى عالم الأفكار. غير أنّ التحول الحاسم في تاريخ المعرفة حدث مع الثورة العلمية الحديثة، حين كُتب مؤلَّف «المبادئ الرياضية للفلسفة الطبيعية» لإسحق نيوتن، ليُرسى به أساسٌ جديدٌ لفهم الطبيعة، وليدخل الرياضيات إلى قلب الفلسفة، فتحوّل التأمل في الكون إلى نموذج يمكن قياسه والتنبؤ به. ومنذ ذلك الحين، غدت التجربة والعقل العلمي مصدرًا أصيلًا للمعرفة، بعد أن تراجعت الفلسفة إلى موقعٍ تأملي يلاحق نتائج العلم أكثر مما يقوده.
لقد وُصف هذا التحوّل بأنه انتصارٌ للعقل التجريبي عند بعض المفكرين كهيوم، بينما عُدّ تهديدًا لجوهر الفلسفة التأملي عند آخرين كهيغل. ومنذ ذلك الوقت، بدأت المعرفة تُبنى على أساس النموذج العلمي الذي يرسم خريطةً للواقع تربط الماضي بالحاضر وتفتح باب التوقع للمستقبل. وأصبحت اللغة الرياضية وسيلة التعبير عن الطبيعة، فازدادت الدقة وارتفع وضوح التنبؤ، فيما غدت قابلية الخطأ شرطًا للصدق العلمي. فالعلم لا يقدّس أفكاره، بل يُعرّضها للاختبار الدائم، لتُقوَّم أو تُستبدل متى ما ظهر قصورها.
ومن هنا، بات يُنظر إلى النظريات العلمية بوصفها مراحل متعاقبة في مسيرة الفهم، لا حقائق نهائية. فما إن ضاق نموذجٌ عن تفسير بعض الظواهر حتى حلّ محله نموذج أوسع. وهكذا أُبدلت فيزياء نيوتن الكلاسيكية بميكانيكا الكم والنسبية، لتُكتشف عوالم جديدة أكثر دقة وتعقيدًا.
ومن رحم هذه التحوّلات، وُلدت الفتوحات المعرفية الكبرى او الثورات العلمية كما وصفها توماس كون التي غيّرت نظرة الإنسان إلى الكون. حين وُضعت الشمس في مركز النظام الكوني على يد كوبرنيكوس، وتولّت قوانين كيبلر تأكيدها، ثم ثبّتها غاليليو بملاحظاته التلسكوبية، تغيّر موقع الإنسان في الكون؛ فلم يعد مركزه، بل كائنًا يدور في نظامٍ أعظم. وحين صيغت نظرية التطور، لم تُفهم الحياة بوصفها سلسلة من الثبات، بل كعملية انتقاء طبيعي مستمرة تُشكّل الكائنات عبر الزمن. ومن خلالها أُعيد تصور الحياة بوصفها حركة دائمة من التحوّل لا تعرف السكون.
وهكذا أصبحت الطبيعة تُرى في حركةٍ مستمرة، والعشوائية تُفهَم كاحتمال منظم يمكن التنبؤ به جزئيًا، والمعرفة تُدرَك ككائن حيٍّ يتطور كما تتطور الكائنات التي تُدرَس. لم تعد الحقيقة حجرًا صلبًا يُمسك به، بل نهرًا من المعاني يتغيّر مجراه مع تغيّر الأدوات والنظريات التي تُفسّره. ومع كل أداة جديدة تُصنع رؤية جديدة للعالم، ومع كل نظرية يُعاد رسم حدود ما يُعتقد أنه الحقيقة.
وقد ترك هذا الوعي أثره العميق على الفلسفة ذاتها، إذ لم تعد الحقيقة تُرى كجوهر ثابت، بل كعملية خلقٍ دائمة. كتب نيتشه في «سقوط الأصنام» أن مأساة الفلاسفة أنهم سعوا إلى تحنيط الحقيقة، بينما هي بطبيعتها متحركة ومتجددة، لا تعيش إلا حين تتغيّر.
في هذا السياق، ظلّ السؤال القديم عن العلاقة بين العقل والجسد يطلّ برأسه. فمع تقدّم علوم النفس والأعصاب، أُعيد البحث عن الكيفية التي ينبثق بها الوعي من الدماغ، وعن الطريقة التي تتحوّل بها المادة إلى تجربة ذاتية. لكن على الرغم من كل ما أُنجز، لم تُقدَّم بعد إجابة قاطعة؛ فما زال سرّ الوعي قائمًا، وما زالت العلاقة بين الدماغ والعقل تُدرس لتُفهم.
وفي ضوء ذلك، اصبحت دراسة الوعي ومصادر الإدراك من أهم مفاتيح الفهم في العصر الحديث. فبقدر ما يُفهم العقل، تُعاد صياغة العلاقة بين الإنسان والعالم. وربما يُكتشف في النهاية أن الحقيقة أن العالم الذي يُرى ليس سوى الصورة التي يُعيد العقل رسمها باستمرار، كلما اتسعت مداركه وتعمّق وعيه.